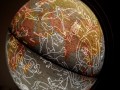الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
«الزين» في المغرب
«الزين» في المغرب

علي العمودي
على مدى سنين عدة أتردد على المغرب الشقيق، البعيد جغرافيا، القريب وجدانيا، سائحا وزائرا وضيفا على مهرجاناته العديدة، الثقافية والفكرية تحديدا، والتي تقام على مدار العام في مدنه المختلفة ذات الجغرافيا والتضاريس المتنوعة.
دخلته عبر صالات السفر المكتظة بركاب الدرجة السياحية، ومن القاعات الشرفية في ذات المطارات، توغلت فيه من تطوان وطنجة شمالا وفاس ومكناس وحتى أكادير والعيون جنوبا، وما بينهما من مدن وقرى وبلدات تحمل في أغلبها أسماء وأضرحة لمن يرونهم أولياء الله الصالحين.
ركبت مع بسطاء الناس «الطاكسي الكبير» وموديلاته التي يعود بعضها لما قبل «ازديادي»، يتنقلون بها نحو أماكن بعضها ناء وأخرى مجاورة، أحاديثهم المشتركة مكابدة أعباء الحياة، والسعي للقمة العيش الشريف.
كما تنقلت بـ«الطاكسي الصغير»، وقطارات وعربات «المترو» الزاهية والنظيفة، ومحطاتها الأكثر نظافة وأناقة في الرباط ومراكش والدار البيضاء.
أحدث زياراتي كانت قبل أيام من ضجة واسعة أثارها فيلم «الزين لي فيك»، الذي يصب في ذات الاتجاه الذي يريد أعداء المغرب دمغه به مرتعا للمتعة الرخيصة والابتذال. دون أن يدركوا أن «الزين» الدائم التواجد في المغرب يتجسد في روح الملايين من شعبه العظيم وتاريخه الأعظم. رجال ونساء شرفاء يأسرونك بكرمهم ونبلهم في بلد يعد قبلة أجداد الأجداد الذين جاؤوه من جزيرة العرب، والفاتحين الأوّل في أرض كانت موئلا ومنطلقا لفتح عظيم باتجاه الأندلس وأوروبا، وظلت دوما مهدا لتلاقح الثقافات والتعايش بين الأديان والأعراق لتُبني الحضارات.
«الزين» الذي نراه في المغرب، مساره الوطني وتجربة بنائه السياسي الذي يستلهم الحكمة والنضج على امتداد تاريخه المعاصر منذ قائد الاستقلال محمد الخامس، ومرورا بمرحلة الحسن الثاني رحمهما الله، وحتى اليوم في عهد الملك محمد السادس ومعركته التنموية للقضاء على الفقر والعشوائيات ووضع أقتصاد البلاد في مسار يليق بأرض غنية بالإنسان والثروات الطبيعية، وبالخصوص الزراعة والمصايد البحرية.
وعلى امتداد كل العصور ظل المغرب وفيا لانتمائه العربي والإسلامي وفضائه «الآورومتوسطي»، وأقرب وأبلغ مثال، مشاركته أشقاءه في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل».
سيظل «الزين» في المغرب عصيا على خدوش الذين يعانون عمى البصر والبصيرة مهما طغى ضجيجهم، وعلت أبخرة شعوذتهم وتخرصاتهم.
GMT 01:24 2026 السبت ,31 كانون الثاني / يناير
أجمل هدف لم يأتِ فى الدورى!GMT 01:22 2026 السبت ,31 كانون الثاني / يناير
مشهد رخيص من موسكوGMT 01:20 2026 السبت ,31 كانون الثاني / يناير
كروان السينما «المُلك لك لك لك»GMT 01:17 2026 السبت ,31 كانون الثاني / يناير
سنة أولى برلمانGMT 01:15 2026 السبت ,31 كانون الثاني / يناير
جنوب لبنان بين الإسناد والسندGMT 01:13 2026 السبت ,31 كانون الثاني / يناير
السيادة الوطنية... مبدأ تحت الحصارGMT 01:11 2026 السبت ,31 كانون الثاني / يناير
عبد الرحمن الراشد... ومشروع «النَّاصرية»GMT 01:08 2026 السبت ,31 كانون الثاني / يناير
البيت الأبيض وامتياز التفاوضترمب يعلن إغلاقًا جزئياً رغم التوصل لاتفاق تمويل في اللحظة الأخيرة
واشنطن - صوت الإمارات
أعلنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية إغلاقاً جزئياً، بعد أن بدأ انقطاع التمويل رسمياً منتصف ليل السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، رغم أن مجلس الشيوخ وافق في اللحظات الأخيرة على اتفاق تمويل يغطي معظم الوكالات حتى س...المزيدروس كوسموس تطوّر منظومة جديدة لمراقبة سلامة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية
موسكو - صوت الإمارات
طوّرت مؤسسة "روس كوسموس"، منظومة جديدة ستستخدم في مراقبة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية للتحقق من سلامة هياكلها أثناء تواجدها في الفضاء. وقالت المؤسسة إن المنظومة الجديدة التي تدعى "نظام التصوير المس...المزيدفاطمة غندور توثّق الذاكرة والإنسان في كتابها الجديد "مصر في عيون ليبية"
القاهرة - شيماء عصام
في كتابها الجديد «مصر في عيون ليبية»، تفتح الكاتبة والصحفية الليبية فاطمة غندور نافذة إنسانية على مصر، لا بوصفها مكانًا عابرًا أو موضوعًا للكتابة، بل كمساحة معيشة وتجربة ممتدة تشكّلت عبر التفاصيل اليومية وا�...المزيدزوجة ليفاندوفسكي تلمح لنهاية مشواره مع برشلونة هذا الموسم
مدريد - صوت الإمارات
يبدو أن مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع نادي برشلونة يقترب من نهايته، على الأقل وفق ما ألمحت إليه زوجته آنا ليفاندوفسكي، التي توقعت أن يكون الموسم الحالي هو الأخير للمهاجم المخضرم بقميص الفريق الكتالون...المزيددراسة حديثة تعيد النظر في فهم الاكتئاب والقلق بعد اكتشاف جذور وراثية مشتركة
واشنطن - صوت الإمارات
كشفت دراسة حديثة أن عدداً من الاضطرابات النفسية قد يشترك في عوامل وراثية واحدة، ما يشير إلى أن أجزاء من الحمض النووي قد تمثل السبب الجذري لأكثر من حالة نفسية، وفقاً لما نقلته شبكة «فوكس نيوز». وحسب بيان صحافي،...المزيدنجمات الدراما السورية يخطفن الأنظار بإطلالات راقية في حفل Joy Awards
الرياض - صوت الإمارات
سجّلت النجمات السوريات حضوراً لافتاً في حفل Joy Awards 2026، حيث تحولت السجادة البنفسجية إلى مساحة استعراض للأناقة الراقية والذوق الرفيع، في مشاركة حملت رسائل فنية وجمالية عكست مكانة الدراما السورية عربياً. وتنوّعت الإطلالات بين التصاميم العالمية الفاخرة والابتكارات الجريئة، في مزيج جمع بين الكلاسيكية والعصرية، وبين الفخامة والأنوثة. كاريس بشار خطفت الأنظار بإطلالة مخملية باللون الأخضر الزمردي، جاءت بقصة حورية أبرزت رشاقتها، وتزينت بتفاصيل جانبية دقيقة منحت الفستان طابعاً ملكياً. واكتملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة ولمسات جمالية اعتمدت على مكياج سموكي وتسريحة شعر كلاسيكية مرفوعة، لتحتفل بفوزها بجائزة أفضل ممثلة عربية بحضور واثق وأنيق. بدورها، أطلت نور علي بفستان كلوش داكن بتصميم أنثوي مستوحى من فساتين الأميرات، تميز بقصة مكش...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©