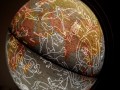الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
مع المعلم
مع المعلم

بقلم - علي العمودي
نواصل حديث الأمس عن المعلم والحرص على تمكينه والارتقاء به باعتباره مفتاح العبور بالأجيال للمستقبل المنشود والتعامل مع أدواته وتحدياته.
قبل أيام عدة عبرت بعض أوساط أمور الطلاب وبالذات في مدارس خاصة كبرى عن قلقها من معايير اختيار المعلمين والمعلمات وشهادات حسن السيرة والسلوك وبكلام أدق صحائفهم الجنائية، وذلك في أعقاب وفاة مدرسة أجنبية بجرعة زائدة من المخدرات في مطار مانشستر عندما كانت بانتظار رحلة تقلها إلى دبي حيث تعمل.
وقد نشر الخبر حينها في مختلف وسائل الإعلام. تساؤل مشروع ليس فقط لأولياء الأمور وإنما لكل فرد في المجتمع، ولكن ما ليس مبرراً أن تستغل واقعة كهذه لمحاولة النيل من جهد عظيم مبذول في هذا القطاع الحيوي الذي هو على تماس مع كل بيت. واستعاد البعض تجربة «النيتف سبيكرز»، والتي اندثرت مع ما جلبت معها.
وكل ذلك لا يبرر حجم الهجمة الشرسة التي تخفي خلفها مآرب وغايات غير بريئة.
وإذا كان هذا البعض يبرز النماذج التي لا نقول إنها سيئة بل غير موفقة، فإننا نبرز وبالإيجابية التي تعودنا عليها نماذج ومبادرات إيجابية ومشرفة ومن ذات الميدان التربوي والتعليمي الذي يحاولون الطعن فيه والإساءة إليه. فقبل أيام أيضاً زارنا جوزيف مكهيو وزير التعليم الأيرلندي الذي كان يعمل معلماً في دبي قبل أن يعود إلى بلاده ويتدرج حتى تبوأ هذا المنصب الرفيع. ومن الإمارات ودبي تحديداً خرجت مبادرة جائزة أفضل معلم في الإمارات وقيمتها مليون درهم، وفي العالم العربي والعالم بقيمة مليون دولار. والشاهد في كل ذلك الحرص على المعلم وتقديره وتكريمه والارتقاء به، والفخر برسالته وما يقدم للمجتمع والوطن.
ومن أرض الإمارات أيضاً كان التفاعل مع المدرس والعمل على الاعتناء به عبر جملة من المبادرات السامية وعلى المستويات كافة.
من حق كل ولي أمر أن يقلق فهو يودع فلذة كبده أمانة لدى المؤسسة التعليمية الحكومية أو الخاصة لمساعدته على تربية وتعليم ابنه أو ابنته التعليم والإعداد والتأهيل الصحيح. وقد كانت هذه المؤسسة دائماً محل الثقة والتقدير وهي ترفد الساحة والوطن سنوياً بأجيال من الطلاب الذين يحققون أعلى وأفضل معدلات النجاح، ولينخرطوا في مسيرة العطاء والعمل. ومن هنا علينا إدراك الحقيقة والخط الفاصل بين القلق المشروع وبين غايات الذين يتفننون في الغمز واللمز لإرضاء نفوسهم المريضة وأفكارهم وتوجهاتهم الملوثة.
GMT 21:31 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر
كهرباء «إيلون ماسك»؟!GMT 22:12 2024 الثلاثاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر
لبنان على مفترق: السلام أو الحرب البديلةGMT 00:51 2024 الأربعاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر
مسألة مصطلحاتGMT 19:44 2024 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر
هؤلاء الشيعة شركاء العدو الصهيوني في اذلال الشيعة!!GMT 01:39 2024 الجمعة ,11 تشرين الأول / أكتوبر
شعوب الساحاتترمب يعلن إغلاقًا جزئياً رغم التوصل لاتفاق تمويل في اللحظة الأخيرة
واشنطن - صوت الإمارات
أعلنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية إغلاقاً جزئياً، بعد أن بدأ انقطاع التمويل رسمياً منتصف ليل السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، رغم أن مجلس الشيوخ وافق في اللحظات الأخيرة على اتفاق تمويل يغطي معظم الوكالات حتى س...المزيدروس كوسموس تطوّر منظومة جديدة لمراقبة سلامة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية
موسكو - صوت الإمارات
طوّرت مؤسسة "روس كوسموس"، منظومة جديدة ستستخدم في مراقبة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية للتحقق من سلامة هياكلها أثناء تواجدها في الفضاء. وقالت المؤسسة إن المنظومة الجديدة التي تدعى "نظام التصوير المس...المزيدفاطمة غندور توثّق الذاكرة والإنسان في كتابها الجديد "مصر في عيون ليبية"
القاهرة - شيماء عصام
في كتابها الجديد «مصر في عيون ليبية»، تفتح الكاتبة والصحفية الليبية فاطمة غندور نافذة إنسانية على مصر، لا بوصفها مكانًا عابرًا أو موضوعًا للكتابة، بل كمساحة معيشة وتجربة ممتدة تشكّلت عبر التفاصيل اليومية وا�...المزيدزوجة ليفاندوفسكي تلمح لنهاية مشواره مع برشلونة هذا الموسم
مدريد - صوت الإمارات
يبدو أن مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع نادي برشلونة يقترب من نهايته، على الأقل وفق ما ألمحت إليه زوجته آنا ليفاندوفسكي، التي توقعت أن يكون الموسم الحالي هو الأخير للمهاجم المخضرم بقميص الفريق الكتالون...المزيددراسة حديثة تعيد النظر في فهم الاكتئاب والقلق بعد اكتشاف جذور وراثية مشتركة
واشنطن - صوت الإمارات
كشفت دراسة حديثة أن عدداً من الاضطرابات النفسية قد يشترك في عوامل وراثية واحدة، ما يشير إلى أن أجزاء من الحمض النووي قد تمثل السبب الجذري لأكثر من حالة نفسية، وفقاً لما نقلته شبكة «فوكس نيوز». وحسب بيان صحافي،...المزيدنجمات الدراما السورية يخطفن الأنظار بإطلالات راقية في حفل Joy Awards
الرياض - صوت الإمارات
سجّلت النجمات السوريات حضوراً لافتاً في حفل Joy Awards 2026، حيث تحولت السجادة البنفسجية إلى مساحة استعراض للأناقة الراقية والذوق الرفيع، في مشاركة حملت رسائل فنية وجمالية عكست مكانة الدراما السورية عربياً. وتنوّعت الإطلالات بين التصاميم العالمية الفاخرة والابتكارات الجريئة، في مزيج جمع بين الكلاسيكية والعصرية، وبين الفخامة والأنوثة. كاريس بشار خطفت الأنظار بإطلالة مخملية باللون الأخضر الزمردي، جاءت بقصة حورية أبرزت رشاقتها، وتزينت بتفاصيل جانبية دقيقة منحت الفستان طابعاً ملكياً. واكتملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة ولمسات جمالية اعتمدت على مكياج سموكي وتسريحة شعر كلاسيكية مرفوعة، لتحتفل بفوزها بجائزة أفضل ممثلة عربية بحضور واثق وأنيق. بدورها، أطلت نور علي بفستان كلوش داكن بتصميم أنثوي مستوحى من فساتين الأميرات، تميز بقصة مكش...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©