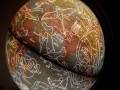الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
«بسمة موسى».. المقاتلةُ بابتسامة
«بسمة موسى».. المقاتلةُ بابتسامة

فاطمة ناعوت
بقلم - فاطمة ناعوت
مشَتْ على زجاجِ الوطن حافيةً
فجرحتها شظايا الفُرقةِ والإقصاء.
طبيبةُ الفَمِ التى علَّمتنا
أن الفمَ المغلقَ شريكٌ فى الجريمة.
أصلحتْ عظامَ الوجوه المُهشَّمة
لكن يدَ الظلام كسَّرتْ ملامحَها فى الدفاتر
ومَن يُطبِّبُ وجهَ العدالة؟
رحلتْ
لكن ظِلَّها ما زال يمشى فى ممرَّاتِ الحقِّ الضيِّقة
يدقُّ الأبوابَ ويقرعُ النواقيسَ
حتى يتعلَّمَ الصخرُ أن يتنفس بحُريَّة ودون وصاية.
بالأمس، حضرنا حفل تأبين الدكتورة «بسمة موسى»، أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين بكليَّة طب الأسنان، جامعة القاهرة. طبيبة لامعة، وناشطة مدنيَّة قسطت حياتَها بين العيادة وقاعة الدرس، وبين الدفاع الهادئ عن حريَّة الاعتقاد وحقوق المواطنة المتساوية، قبل أن تودِّعنا فى نوفمبر ٢٠٢٥ بعد رحلة طويلة من التحديات المريرة، والانتصارات الصغيرة فى وجه التمييز العَقَدى. لم تمُت الدكتورة «بسمة» رحمها الله بسبب المرض فقط، ولا بسبب سنوات العزلة التى قضتها اختيارًا بعيدًا عن الناس فى أواخر حياتها، بل كذلك لأنها عاشت تحت ضغط أعراف إقصائيَّة تُرهق المختلفَ حدَّ الإنهاك. رغم أن كتابَ الله واضحٌ حين يقول: «ولو شاءَ ربُّكَ لجعلَ النَّاسَ أُمَّةً واحدةً ولا يزالونَ مختلفين» (هود - ١١٨).
كانت طبيبة مميزة نذرت عِلمها وعُمرها لتخفيف آلام المرضى، ومعالجة وتقويم الوجوه، بينما ظلَّت يدُ التطرف تحاول كسر وجهها كل يوم لأنها «بهائيَّة». لم تطلب أى امتيازات، بل طلبت أبسط حقوق الإنسان التى يكفلها الدستورُ: أن تُكتب فى دولتها كما هى دون نفاق ولا تقيَّة. أن تُحيا بما تؤمن، وتُعامل كمواطنة لا كاستثناء، وأن تجد مقبرةً تضم جسدها بعد الرحيل.
بعد تخرجها بتفوق من كليَّة طب الأسنان بجامعة القاهرة، واجهتْ مصاعبَ وعراقيلَ أكاديميَّة غير مبررة فى مسار الماجستير والدكتوراه. شهد زملاؤها بمحاولات عرقلة مسيرتها الأكاديميَّة، لولا تدخل إدارة الجامعة لإنصافها. ورغم تلك الحياة الحافلة بالنضال ضد التهميش والظلم، لم تفقد عذوبة حضورها ولا ابتسامتَها الشهيرة التى يعرفها مرضاها وتلاميذُها وجميعُ من اقترب من عالمها. كانت تحاربُ «الظلم» بسلاح «الابتسامة»، لا بالهتاف والصراخ والشكوى، تمامًا مثلما عاش الفنان المصرى العالمى «حسين بيكار» يحارب الإقصاءَ بالريشة والعود.
«بيكار» الذى تربَّينا، نحن أبناءَ السبعينيَّات والثمانينيَّات، على ريشته وألوانه قبل أن نتعرَّف على اسمه أو اسم الوطن. سكنت رسوماتُه الجميلة صفحات كتب المدرسة كطيورٍ ملونة تكاد تصدحُ من قلب الورق، تُعلِّمُنا الرقَّة والخيال والرحمة. بفضل ريشته تعلَّمنا أن الوجه الإنسانى يمكن أن يكون حكاية، وأن الخط البسيط قادر على حمل قيمة الأخلاق. كبرنا على رسوماته وأدركنا أن الفنَّ ليس زينةً، بل تربيةً للضمير. «بيكار»: رسم الوجوه لنتعرف على وجه الإنسانية، و«بسمة»: رمَّمت العظامَ لتصون وجه الإنسانية. كلاهما صنع معجزته تحت ضغط الإقصاء وعذاب رفض الاختلاف الذى هو سُنَّة الله فى خلقه. وهى الدوامة نفسها التى يعيشها كل بهائى يحاول استخراج شهادة ميلاد أو بطاقة أو وثيقة زواج. منهم أستاذة جامعيَّة، رفيعة المقام، عالية الثقافة، تجاوزت السبعين من عمرها، وصارت جدَّة، ومع هذا مازالت تحمل لقب «آنسة!» فى بطاقتها الشخصية: الدكتورة «سوسن حسنى».
ووفق تقارير حقوقيَّة موثقة، عاش البهائيون كوابيسَ مرعبة عام ٢٠٠٩ فى قرية «الشارونيَّة» من إحراق بيوتهم وتهجيرهم قسرًا، ومازالوا يعانون كابوسًا مخيفًا حين لا يعرفون أين سيدفنون موتاهم لأن المقبرة الوحيدة المخصصة لهم فى القاهرة، وقد امتلأت، وغير مصرح لهم تشييدُ مقابرَ أخرى فى المحافظات؛ ما يضطرهم لنقل الجثامين مئات الكيلومترات لدفنها. هذه الجملة التى تُكتب فى ثوانٍ فى مقال كهذا، هى فى واقعها عذابٌ مقيم وضغطٌ نفسى يعيشه أشقاءٌ لنا فى الوطن، لهم، بنصِّ الدستور، كاملُ حقوق المواطنة، لكن الأعرافَ الإقصائيَّة وأبواقَ التطرف تضنُّ عليهم بحقوقهم البسيطة. هذا الإقصاء لا ينسجم مع دولة تتبنى مفهوم المواطنة والمدنيَّة. فالدينُ شأنٌ خاصٌّ بين الإنسان وربِّه، أمَّا المواطنة فهى الشأنُ العام والمظلة التى ينبغى أن تتسع لجميع أبناء الوطن.
نخطئ أخلاقيًّا حين نعتبر معاناة أشقائنا البهائيين «قضيَّة أقلية». فالمواطنون ليسوا «أقليَّةً» مهما قلَّ عددهم. إنما هى قضيَّة مصر مع نفسها. قضيَّة ترفع إصبع الاتهام فى وجوهنا وتتساءل: هل نحن وطن للمواطنين، أم نادٍ للمتشابهين؟ المجتمعاتُ التى لا تحترمُ التعدديَّة وحقَّ الاختلاف، محكومٌ عليها بالشقاق والتفسُّخ. ومصرُ فى «الجمهوريَّة الجديدة» ودَّعَتْ تلك الآفات المريضة التى عفا عليها الزمنُ.
رحم الله الدكتورة «بسمة موسى» التى لم تمُتْ، بل ماتت الورقةُ التى أرادت محوها.
GMT 01:24 2026 السبت ,31 كانون الثاني / يناير
أجمل هدف لم يأتِ فى الدورى!GMT 01:22 2026 السبت ,31 كانون الثاني / يناير
مشهد رخيص من موسكوGMT 01:20 2026 السبت ,31 كانون الثاني / يناير
كروان السينما «المُلك لك لك لك»GMT 01:17 2026 السبت ,31 كانون الثاني / يناير
سنة أولى برلمانGMT 01:15 2026 السبت ,31 كانون الثاني / يناير
جنوب لبنان بين الإسناد والسندموقع إكسيوس يكشف عن خلاف أمريكي إسرائيلي بعد قصف مستودعات الوقود الإيرانية
واشنطن ـ محمد صالح
كشف موقع أكسيوس الأمريكي، بأن الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل السبت على نحو 30 مستودع وقود في إيران أثارت أول خلاف ملحوظ بين الولايات المتحدة وإسرائيل منذ اندلاع الحرب قبل ثمانية أيام. ونقل الموقع عن مسؤولين أمر...المزيدمدير أعمال الفنان هاني شاكر يطمئن الجمهور على حالته الصحية
القاهرة - صوت الإمارات
طمأن مدير أعمال الفنان هاني شاكر الجمهور على حالته الصحية بعد انتشار شائعات خلال الساعات الماضية حول وفاته، مؤكداً أن حالته مستقرة وتشهد تحسناً ملحوظاً، وأن ما يتم تداوله بشأن وفاته لا أساس له من الصحة. وأوضح أن ال...المزيدروس كوسموس تطوّر منظومة جديدة لمراقبة سلامة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية
موسكو - صوت الإمارات
طوّرت مؤسسة "روس كوسموس"، منظومة جديدة ستستخدم في مراقبة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية للتحقق من سلامة هياكلها أثناء تواجدها في الفضاء. وقالت المؤسسة إن المنظومة الجديدة التي تدعى "نظام التصوير المس...المزيدفاطمة غندور توثّق الذاكرة والإنسان في كتابها الجديد "مصر في عيون ليبية"
القاهرة - شيماء عصام
في كتابها الجديد «مصر في عيون ليبية»، تفتح الكاتبة والصحفية الليبية فاطمة غندور نافذة إنسانية على مصر، لا بوصفها مكانًا عابرًا أو موضوعًا للكتابة، بل كمساحة معيشة وتجربة ممتدة تشكّلت عبر التفاصيل اليومية وا�...المزيدإنفانتينو يؤكد ترحيب ترامب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
لندن - صوت الإمارات
أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة منتخب إيران في النسخة المقبلة من كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقال إنفا...المزيدنجمات الدراما السورية يخطفن الأنظار بإطلالات راقية في حفل Joy Awards
الرياض - صوت الإمارات
سجّلت النجمات السوريات حضوراً لافتاً في حفل Joy Awards 2026، حيث تحولت السجادة البنفسجية إلى مساحة استعراض للأناقة الراقية والذوق الرفيع، في مشاركة حملت رسائل فنية وجمالية عكست مكانة الدراما السورية عربياً. وتنوّعت الإطلالات بين التصاميم العالمية الفاخرة والابتكارات الجريئة، في مزيج جمع بين الكلاسيكية والعصرية، وبين الفخامة والأنوثة. كاريس بشار خطفت الأنظار بإطلالة مخملية باللون الأخضر الزمردي، جاءت بقصة حورية أبرزت رشاقتها، وتزينت بتفاصيل جانبية دقيقة منحت الفستان طابعاً ملكياً. واكتملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة ولمسات جمالية اعتمدت على مكياج سموكي وتسريحة شعر كلاسيكية مرفوعة، لتحتفل بفوزها بجائزة أفضل ممثلة عربية بحضور واثق وأنيق. بدورها، أطلت نور علي بفستان كلوش داكن بتصميم أنثوي مستوحى من فساتين الأميرات، تميز بقصة مكش...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©