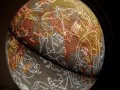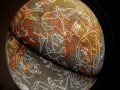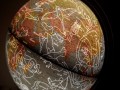الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
محنة في المدرسة
محنة في المدرسة

بقلم - سوسن الأبطح
الانقلابات والتحولات العالمية تسبق قدرة التربويين على التأقلم، وفهم المطلوب منهم لتهيئة جيل قادر على مواجهة الحياة، والعثور على فرص عمل.
لذلك، التعليم ليس بخير. والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أطلق نداءً عاجلاً، يطالب فيه دول العالم أجمع بـ«إصلاحات جذرية» في نظمها التعليمية، محذراً من أن أي دولة لا تستجيب للنداء «تخاطر بالتخلف عن الركب». فقد تكشّفت الأرقام عن تدهور غير مسبوق، و«أزمات عميقة تعاني منها المدرسة، في الدول النامية والمتقدمة، على حد سواء».
المعضلة ذات وجهين؛ تسرّب غير مسبوق، وبالتالي انتشار للأمية، وقصور في المستوى، حتى عند من يلتحقون بالمدارس والجامعات.
تم إحصاء 358 مليون طفل هم اليوم خارج النظم التعليمية. رقم قياسي، يصل إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه الحال، قبل ست سنوات فقط. حالة وصفتها مديرة صندوق «التعليم لا يمكن أن ينتظر» ياسمين شريف، بأنها «صادمة ومخزية».
الأزمة تستفحل في الدول الفقيرة والمتوسطة؛ لكن غوتيريش لا يخفي أن «أغلب أنظمة التعليم المعمول بها لا تزال عالقة في الماضي. ومناهج التدريس، كما طرق تدريب المعلمين، عفّى عليها الزمن»، الأمر الذي يترك الخريجين بلا مهارات كافية، في أسواق عمل سريعة التغير، وتحتاج تأهيلاً ديناميكياً، لم يتوفر بالقدر بعد.
50 في المائة من تلامذة المدارس في سن العاشرة، في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، غير قادرين على قراءة النصوص؛ لكن الأمر قد لا يدعو إلى كبير تفاؤل، في دول تصنف متقدمة تعليمياً. حتى المقاييس الدولية لمستوى التعليم بات مشكوكاً بها، وكل منها تعطي مؤشراتها، نتائج مختلفة عن الأخرى، تبعاً لأمزجة وأهداف واضعي الاختبارات.
فهل ثمة من يملك الكلمة الفصل في توصيف ما هو التعليم الجيد؟ وأي مهارات يحتاجها التلميذ في كل مرحلة، وما الذي يتوجب حذفه، أو تستحسن إضافته، كي نصل بطلابنا إلى برّ الأمان؟
تعيش البشرية على فالق زلزالي خطير، وتحاول أن تجتهد، وتصيب أكثر مما تخيب.
هذا ما يفعله 140 وزير تربية يجتمعون في «اليونيسكو»، ليقدموا تصوراتهم، حول التحولات في التعليم التي لا بد منها. دول مثل الغابون أو كينيا تسرع الخُطا، وبلد على شاكلة لبنان يشله غياب الكهرباء وسوء خدمة الإنترنت، يضطر للتعليم عن بعد، جزئياً، حتى بعد انحسار الوباء؛ لأن الوصول إلى المؤسسات التعليمية فوق طاقة الأساتذة، وهو ما قد ينسحب على دول أخرى مع ارتفاع أسعار الطاقة، وشحّها.
الخبراء يؤكدون أن التحول المنشود سيمر من خلال جعل التعليم تفاعلياً، والاستغناء عن اعتماد النصوص وحدها. لا بد من روبوتات تجيب عن الأسئلة المتنامية للطلاب، ومن الاستفادة من تقنيات تحول النص المقروء إلى مسموع، وتسهيل تحويل صوت الطالب أو الأستاذ بشكل آلي إلى نص، لتمكين من يرغب في العودة إليه، واللجوء إلى تطبيقات متخصصة في كل مادة، لمساعدة الأستاذ في تعليم الطالب. كل هذا ولم نتحدث بعد عن الواقع المعزز الذي سيسهم في خلق صفوف افتراضية بالكامل موازية للصفوف الواقعية.
يبدو الأمر مثالياً، ورائعاً، خارجاً من عالم الخيال العلمي. وتظن أنه سيطبق في عوالم نحتاج أزمنة لنصلها؛ لكن الوقائع أثبتت أن البشرية تعيش إيقاعاً واحداً متناغماً إلى حد مقلق، وأن التطبيق سيكون في أميركا كما في البرازيل وأوغندا، وما ستختلف هي الآليات، والقدرة على التأقلم والتلقي.
وحين يتساوى الجميع في الأدوات، من دون امتلاك الخلفيات ووضوح الرؤية، حينها، تدبّ الفوضى.
تطمئن «اليونيسكو»، بطريقتها الدبلوماسية، إلى أن التأقلم مع الجديد له تاريخه المديد. فقد نشر المدرّس كالب فيليبس، قبل 200 سنة، عبر صحيفة «بوسطن غازيت» دروسه الأسبوعية، واستفاد منها الطلاب. وعندما حطّ الراديو لم تتأخر «جامعة بنسلفانيا» عن بث الدروس عبره لطلابها، ثم كانت الاستفادة من التلفزيون للتوجه للتلامذة ببرامج تعليمية أتت أكلها، وحين وصل الكومبيوتر مطلع الثمانينات، استفيد منه في تطوير العملية التعليمية، ومع شبكة الإنترنت عام 1992 بدأت تظهر الدروس الإلكترونية. وهذا كله صحيح. تحيا التكنولوجيا، وتباً لمن يطالب بالتخلف عن ركبها.
لكن الفرق هذه المرة، أن التغير لا يطول الوسيلة وحدها، كما كان الحال مع الأدوات السابقة رغم ما واجهته من صدود، وإنما صلب المضمون أيضاً. هناك ضرورة للخروج من المناهج القديمة، والبحث عن بدائل تناسب عصراً له متطلبات استثنائية. ثمة فرق بين التطوير والسعي إلى تشييد بناء معرفي جديد. وهو ما يحتاج من كل دولة أن تكون لها رؤيتها الفلسفية للتعليم وأهدافها منه، بحيث يتوافق مع خططها المستقبلية. ما يجعل التعليم مفتاحاً إما أن نلج به إلى الخلاص وإما نعبر إلى الجحيم.
لا شيء أكيد. فليس من بين عشرات الوزراء المجتمعين في «اليونيسكو» في باريس، الراسمين للخطط، والذاهبين إلى الأمم المتحدة في نيويورك، في شهر سبتمبر (أيلول) لاستكمال البحث، من يملك معرفة واضحة عما ستكون عليه مدرسة عام 2030 التي يسعون إليها. هناك من يقول إنها ستكون افتراضية جزئياً، أو لا مركزية، قد يقضي التلميذ غالبية وقته في التعلم البيتي، أو جزءاً منه في الطبيعة. هناك من يعتقدها بلا أستاذ، أو أن التعليم يجري مناصفة بين معلم وهولوغرامه، وقد لا تستخدم غير الشاشات، وتعتمد الأفلام والألعاب حتى في التقييم والاختبار.
المخاوف لا تتأتى من الجديد؛ بل من أن جيلاً أو جيلين، على الأقل، من الأطفال، سيتحولون إلى حقل لاختبارات تعليمية، لا تشبه ما رأيناه في أي مدرسة، على مرّ تاريخ البشرية، وتلك مغامرة فادحة.
GMT 02:30 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
السادة الرؤساء وسيدات الهامشGMT 02:28 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
«وثائق» عن بعض أمراء المؤمنين (10)GMT 02:27 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
من يفوز بالطالب: سوق العمل أم التخصص الأكاديمي؟GMT 02:26 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
روبرت مالي: التغريدة التي تقول كل شيءGMT 02:24 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
السعودية وفشل الضغوط الأميركيةصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدمنى زكي تؤكد أنها تتأنى دائما في اختياراتها لأعمالها وفيلم "الست" تحدٍ صعب لها
القاهرة - مصر اليوم
تحدثت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها الأخير بجائزة اليسر الذهبي الفخرية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وكشفت عن سر اختيارها لأعمالها الفنية وما تعلمته من كبار المخرجين والنجوم الذين عملت معهم، كما �...المزيدتحقيق يكشف عن تقييد "فيسبوك" للصفحات الإخبارية الفلسطينية
غزة - صوت الإمارات
قيّد موقع فيسبوك بشدة قدرة وسائل الإعلام الفلسطينية على الوصول إلى الجمهور خلال الحرب بين إسرائيل وغزة. وفي تحليل شامل لبيانات فيسبوك، وجدنا أن غرف الأخبار في الأراضي الفلسطينية - في غزة والضفة الغربية - شهدت انخفا�...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©