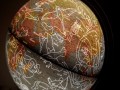الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
ماذا حدث للثقافة فى مصر؟
ماذا حدث للثقافة فى مصر؟

جلال أمين
بقلم: جلال أمين
فى سنة 1938 (أى منذ ثمانين عاما) نشر الدكتور طه حسين كتابا مهما تحت عنوان «مستقبل الثقافة فى مصر»، أحدث دويا واسعا، وظل فترة طويلة يشغل الناس، وعده مؤرخو الثقافة المصرية والعربية علامة مهمة فى تاريخنا الثقافي، يتكرر ذكره واقتطافه المرة بعد المرة، خاصة دعوته إلى الأخذ من الحضارة الغربية بعبارات مدهشة فى حسمها وعموميتها، إذ دعا إلى أن «نسير مسيرة الأوربيين ونسلك طريقهم»، وإلى أن نقبل من هذه الحضارة «خيرها وشرها، وحلوها ومرّها، وما يُحب منها وما يكره، وما يحمد منها وما يعاب».
قامت ثورة 23 يوليو 1952 بعد ظهور كتاب طه حسين بأربعة عشر عاما فعزلت الملك وأعلنت الجمهورية، واتخذت اجراءات ثورية لتغيير النظام الاجتماعي، مما جعلها تستحق وصف الثورة، كما رفعت من تطلعات المثقفين المصريين، وأثارت آمالا واسعة فى إحراز تقدم فى مختلف المجالات: السياسية والاجتماعية والثقافية.
كان اللحاق بالأمم المتقدمة أحد الأهداف التى تبنتها ثورة 1952، فى مختلف المجالات، ومن ثم لم يكن غريبا أن يتخذ رجل مثل طه حسين وزملائه المتحمسين للحضارة الغربية، موقف التأييد والرضا من الثورة، على الأقل فى سنواتها الأولي. فعلى الرغم من كل الشعارات التى بعد الثورة فى السنين العشرين الأولى من حياتها، حتى وفاة طه حسين فى 1973، من معاداة الاستعمار فى كل صوره، لم يصدر من قادة الثورة أى شيء يدل على معاداتهم للحضارة الغربية أو رفضهم لمنجزاتها.
خطر لى بعد هذه الفترة الطويلة على ظهور كتاب طه حسين أن أتساءل عما حدث لدعوة طه حسين إلى التغريب الشامل، فإذا بى أجد أن ما حدث فاق أى شيء كان يتصوره ويدعو إليه. لقد أتم طه حسين كتابه قبل نشوب الحرب العالمية الثانية، أى قبل قدوم ما يمكن أن يسمى «العصر الأمريكي»، بكل ما أحدثه هذا العصر من تغيرات ثقافية فى العالم كله. وكان طه حسين يكتب فى ظل سيادة الثقافة الأوروبية: الاستعمار الأوروبى كان سائدا ولم يحل محله بعد الاستعمار الأمريكى بسماته الجديدة والغريبة. والحضارة الغربية كانت تحمل سمات الثقافة الأوروبية لا الأمريكية. فما الذى كان يمكن أن تتوقعه من مثقف مصرى كبير، شديد التعلق بالحضارة الأوروبية، ويعتقد أن أفضل ما يمكن أن يحدث للثقافة فى مصر هو أن تحذو خطوات أوروبا بالضبط، وتقتدى بكل ما تفعل، «حلوه ومرّه، ما نحب منه وما نكره». كان طه حسين قد ذاق «المرّ الأوروبي»، ولكنه لم يكن قد ذاق بعد «المرّ الأمريكي»، فماذا عساه أن يقول لو ذاق هذا المرّ مثلنا؟
لقد لعب قدوم العصر الأمريكى بثقافات العالم الثالث الأخري، كما تلعب العاصفة فى البحر بالثقافة المصرية مثلما لعب بالقوارب الصغيرة. جاء العصر الأمريكى بالانقلابات العسكرية (التى تحوّل بعضها إلى ثورات، أو سُميت كذلك)، ولكن سواء كان ما حدث انقلابا أو ثورة، فقد فرض قيودا شديدة على الحريات التى كانت متاحة قبله. أخذ الانتاج الثقافى فى مصر بعد الثورة يعبر عن مصالح طبقات جديدة كانت محرومة من التعبير عن نفسها، عشرات السنين (بل قرونا عديدة)، وأطلق عقال كثير من المواهب التى كانت تتوق إلى التعبير عن هذه الطبقات. ولكن هذا لم يكن بلا ثمن، وإن كان ثمنا لابد من توقعه فى ظل نظام اجتماعى جديد، ونظام سياسى لا يعد نفسه ملزما بإتباع الطقوس الديمقراطية المعهودة.
كان من بين ما دفع ثمنا عاليا لهذا التغيير الاجتماعى اللغة العربية. قد يبدو لنا ما حدث للغة العربية فى مصر خلال الأعوام الخمسين أو الستين عاما الماضية كأنه كان من الممكن تجنبه ولكن الحقيقة أنه كان تطورا شبه حتمي، إذ كان تجنبه يحتاج إلى ما يشبه المعجزة. كيف كان لنا أن نتصور تطبيقا شاملا لمجانية التعليم، والتوسع المفاجئ فى التعليم، فى جميع المدن والقري، مما يتطلب اكتظاظ عشرات التلاميذ فى الحجرة الواحدة، والاستعانة بمدرسين لم يحظوا هم أنفسهم بالدرجة اللازمة من التعليم أو الثقافة، دون أن يحدث تساهل شديد فى تطبيق قواعد اللغة، خاصة أن الأحوال السائدة فى خارج المدرسة كانت تساعد على هذا التساهل؟
كان المسئولون السياسيون الجدد، هم أنفسهم، ذوى ثقافة محدودة، ويعلقون أهمية على النتائج العملية أكثر مما يعلقون على اللغة المستخدمة، التى أصبحت من قبيل «الشكل» الذى تجوز التضحية به فى سبيل «المضمون». كذلك وجد هؤلاء المسئولون الجدد أنفسهم فى حاجة إلى وسائل للدعاية لنظامهم الجديد، لم يشعر المسئولون القدامى بالحاجة إلى مثلها. لكن الدعاية المطلوبة كانت تتطلب بدورها الوصول إلى الجاهل والمتعلم ونصف المتعلم. المهم هو تحقيق الأثر النفسى المنشود، بصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة لتحقيقه. والتساهل فى قواعد اللغة ثمن هين، فى نظر المسئولين، فى سبيل حماية الثورة أو النظام.
ليس هذا فحسب، بل ساد فى ذلك الوقت ما سمى «أفضلية أهل الثقة على أهل الخبرة». وهو شعار يتفق تماما مع التضحية بالوسيلة فى سبيل الغاية المنشودة. ومن بين الوسائل المضحى بها، ليس فقط الالتزام بقواعد اللغة الصحيحة، بل استخدام النوع الأفضل من المثقفين، الذين قد يكونون أفضل حقا، وأكثر خبرة، لكنهم لا يحوزون القدر الكافى من «الثقة»، أى لا يمكن الاطمئنان إليهم كل الاطمئنان فى تحقيق أهداف الثورة «أو أهداف النظام».
استمر كل هذا ما يقرب من عشرين عاما، أى طوال العقدين التاليين لثورة 1952، توفى فى نهايتهما طه حسين دون أن نقرأ له تقييما صريحا لما حدث خلالهما للثقافة المصرية. ولكنى لا أظن أن طه حسين (لو كان قد امتد به العمر)، كان يتصور ما حدث بالفعل للثقافة المصرية فى أعقاب ثورة وطنية علقنا جميعا عليها آمالا كبارا.
>>>
كان من أهم نتائج الحرب العالمية الثانية أن ورثت الولايات المتحدة دول أوروبا الاستعمارية، وأهمها بريطانيا وفرنسا، (مع استثناءات قليلة حل فيها الاتحاد السوفيتى محل هذه الدول الاستعمارية القديمة، لكنه فشل فى الاحتفاظ بها بعد نهاية الثمانينيات). لم تسدل الحرب العالمية الثانية إذن، الستار على ظاهرة الاستعمار، بل استبدلت فقط صورا جديدة للاستعمار بصورته القديمة. كيف يمكن أن نتوقع غير ذلك فى عالم أتسم دائما بسيطرة القوى على الضعيف؟ كان لابد بالطبع أن يتغير أسلوب السيطرة، ونوع الخطاب المستخدم لتبريرها. أما واقعة السيطرة والقهر نفسها، فتظل مستمرة حتى يجد المقهورون طريقة للإفلات. لقد كادت كلمة «الاستعمار» تختفى اختفاءً تاماً بعد أن كنا لا نكف عن استخدامها فى صبانا ومطلع شبابنا، ولكن اختفاء كلمة الاستعمار شيء، وانتهاء الاستعمار نفسه شيء آخر.
نقلا عن الاهرام القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
المصدر :
GMT 21:31 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر
كهرباء «إيلون ماسك»؟!GMT 22:12 2024 الثلاثاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر
لبنان على مفترق: السلام أو الحرب البديلةGMT 00:51 2024 الأربعاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر
مسألة مصطلحاتGMT 19:44 2024 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر
هؤلاء الشيعة شركاء العدو الصهيوني في اذلال الشيعة!!GMT 01:39 2024 الجمعة ,11 تشرين الأول / أكتوبر
شعوب الساحاتترمب يعلن إغلاقًا جزئياً رغم التوصل لاتفاق تمويل في اللحظة الأخيرة
واشنطن - صوت الإمارات
أعلنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية إغلاقاً جزئياً، بعد أن بدأ انقطاع التمويل رسمياً منتصف ليل السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، رغم أن مجلس الشيوخ وافق في اللحظات الأخيرة على اتفاق تمويل يغطي معظم الوكالات حتى س...المزيدروس كوسموس تطوّر منظومة جديدة لمراقبة سلامة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية
موسكو - صوت الإمارات
طوّرت مؤسسة "روس كوسموس"، منظومة جديدة ستستخدم في مراقبة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية للتحقق من سلامة هياكلها أثناء تواجدها في الفضاء. وقالت المؤسسة إن المنظومة الجديدة التي تدعى "نظام التصوير المس...المزيدفاطمة غندور توثّق الذاكرة والإنسان في كتابها الجديد "مصر في عيون ليبية"
القاهرة - شيماء عصام
في كتابها الجديد «مصر في عيون ليبية»، تفتح الكاتبة والصحفية الليبية فاطمة غندور نافذة إنسانية على مصر، لا بوصفها مكانًا عابرًا أو موضوعًا للكتابة، بل كمساحة معيشة وتجربة ممتدة تشكّلت عبر التفاصيل اليومية وا�...المزيدزوجة ليفاندوفسكي تلمح لنهاية مشواره مع برشلونة هذا الموسم
مدريد - صوت الإمارات
يبدو أن مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع نادي برشلونة يقترب من نهايته، على الأقل وفق ما ألمحت إليه زوجته آنا ليفاندوفسكي، التي توقعت أن يكون الموسم الحالي هو الأخير للمهاجم المخضرم بقميص الفريق الكتالون...المزيددراسة حديثة تعيد النظر في فهم الاكتئاب والقلق بعد اكتشاف جذور وراثية مشتركة
واشنطن - صوت الإمارات
كشفت دراسة حديثة أن عدداً من الاضطرابات النفسية قد يشترك في عوامل وراثية واحدة، ما يشير إلى أن أجزاء من الحمض النووي قد تمثل السبب الجذري لأكثر من حالة نفسية، وفقاً لما نقلته شبكة «فوكس نيوز». وحسب بيان صحافي،...المزيدنجمات الدراما السورية يخطفن الأنظار بإطلالات راقية في حفل Joy Awards
الرياض - صوت الإمارات
سجّلت النجمات السوريات حضوراً لافتاً في حفل Joy Awards 2026، حيث تحولت السجادة البنفسجية إلى مساحة استعراض للأناقة الراقية والذوق الرفيع، في مشاركة حملت رسائل فنية وجمالية عكست مكانة الدراما السورية عربياً. وتنوّعت الإطلالات بين التصاميم العالمية الفاخرة والابتكارات الجريئة، في مزيج جمع بين الكلاسيكية والعصرية، وبين الفخامة والأنوثة. كاريس بشار خطفت الأنظار بإطلالة مخملية باللون الأخضر الزمردي، جاءت بقصة حورية أبرزت رشاقتها، وتزينت بتفاصيل جانبية دقيقة منحت الفستان طابعاً ملكياً. واكتملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة ولمسات جمالية اعتمدت على مكياج سموكي وتسريحة شعر كلاسيكية مرفوعة، لتحتفل بفوزها بجائزة أفضل ممثلة عربية بحضور واثق وأنيق. بدورها، أطلت نور علي بفستان كلوش داكن بتصميم أنثوي مستوحى من فساتين الأميرات، تميز بقصة مكش...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©