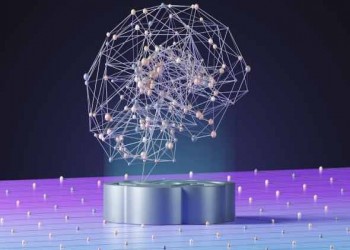الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
سبتمبر... الشبح الحاضر
سبتمبر... الشبح الحاضر

بقلم: بكر عويضة
ليس شبح حادي عشر سبتمبر (أيلول) الأميركي وحده الذي لم يندثر خطره بعد نهائياً، مع أنه اتخذ مقعده المميز في سجلات أحداث الإرهاب بوصفه الأكثر حضوراً في ذاكرة بشر الزمن المعاصر، مذ وقع ضحى ذلك اليوم من عام 2001، أول أعوام ألفية الميلاد الثالثة. يومها، كتبتْ الملكة إليزابيث الثانية تواسي عائلات ضحايا المجزرة، الذين تجاوز عددهم ألفي إنسان، فتضمنت مواساتها الكلمات التالية: «الحزن هو ثمن ندفعه للحب». المقولة ذاتها «Grief Is The Price We Pay For Love» اختارتها «ديلي تلغراف»، إحدى أعرق صحف بريطانيا اليومية، ذات الولاء الثابت للحكم الملكي، وأسرة الملكة، كي تصاحب صورتها على كامل الصفحة الأولى، لعددها الصادر صباح الجمعة الماضي، اليوم التالي لوفاتها.
وقائع الدمار المخيف، الذي وقع على مسمع ومرأى العالم كله يوم 11 سبتمبر 2001، ليست وحدها التي يظل شبحها حاضراً يحمل نُذر احتمال تكرارها. كلا، ثمة نوع آخر من الخوف -ليس بمعنى الجبن، وإنما التحسّب- حريٌّ أن يبقى له حضور دائم في أذهان مخططي الاستراتيجيات الآنيّة، وكذلك المستقبلية، واضعي المناهج التعليمية، متابعي التطورات السياسية، دارسي شؤون التنظيمات الإرهابية، ومن ثم صُناع القرار على مختلف المستويات، إنه الخوف الآخذ في الحسبان إمكانية أن يطوّر النهج الفكري المنتج تنظيم «القاعدة» من شكل مظهره، أن يبدل جلده، أن يحمل من الأسماء ما لم يخطر على البال، فيخرج على الناس باسم «داعش»، مثلاً، وأن يثبت قدرته على التعايش مع أي فيروس مقاوم له، تماماً مثل «كورونا» حين طفق يحوّر ذاته في أشكال عدة، حتى خُيِل للبعض أنه انتهى، وأن أمره انقضى، فيما يؤكد الواقع أنه لم يزل موجوداً، بل ينتعش أيضاً، بعدما أمكنه إقناع ضحاياه بإمكانية العيش إلى جانبه. كذلك هو حال الفكر المتطرف، يستطيع التكاثر كما البعوض، خصوصاً كلما وجد المستنقعات الدافئة، الحاضنة، وبالتالي المرحبة أن يفقس البيض على ضفافها كي تطلق شرورها لاحقاً في غير فضاء، وحيثما تشاء.
صحيح أن اصطياد عناصر قيادية في التنظيمات التي تسمي نفسها «جهادية»، والنجاح في تغييبها عن ساحات الفعل الإرهابي، يربك أحوال القواعد المأمورة من تلك القيادات، وربما يضعفها، وقد يشل حركتها في المدى المنظور، لكن ذلك الاصطياد وحده ليس الحل الحاسم للمشكل. يدرك هذه الحقيقة على نحو أفضل مني، ومن غيري، أهل الاختصاص في حقول الأمن، وهم بالتأكيد الأدرى بكيف يكون حل الخلاص النهائي من آفة الإرهاب باسم الدين الحنيف تحديداً. في الجانب الفكري، يمكن لكل صاحب قلم أن يسهم، بل من الواجب أن يفعل، قدر ما يستطيع، إنما بلا تمنن على أحد، وبلا ادعاء علم أوسع مما يعلم، ولعل الأهم بلا إلباس الذات من أثواب المزايدة على الناس ما ليس يُطاق، فينفر بدل أن ينوّر.
أما على الصعيد الديني، فلم يزل الطريق ممتلئاً بما زُرع من ألغام التنطع والتكفير طوال ما يتجاوز نصف قرن. نزع تلك الألغام، بقصد الحيلولة دون خطر انفجارها المفاجئ هو مهمة العقول المستنيرة في صفوف أفاضل العلماء الذين هم أكثر من غيرهم دراية بمكامن الضعف عند الأجيال الشابة، بوسع زاعمي علم ديني متطرفين استغلالها بغية الانحراف بالشبان والشابات عن الدرب السويّ للعقيدة، سواء بما يتعلق بالشرع، أو بمجمل دروب الحياة.
الأساس ذاته، تقريباً، ينسحب على أكثر من سبتمبر، سابق أو لاحق، ليوم تدمير البرجين في أميركا. هناك سبتمبر ليبيّ قُدر له أن يولَد قبل عام من سبتمبر أردنيّ - فلسطينيّ مؤلم. وثمة سبتمبر يمنيّ (26 - 9 - 1962) سبق الاثنين. هل من الضروري استحضار المزيد؟ كلا. يكفي القول إن ليبيا، التي نَحّت جانباً سنوات فاتح سبتمبر 1969 قبل أحد عشر عاماً، لم تزل تواجه مهمة نَحْت البديل الأصلح حقاً. هل بوسع المواطن الليبي غير الطامح إلى منصب مهم، وغير الطامع في كنز الحكم، الاطمئنان التام إلى أن واقع ليبيا تجاوز احتمال الانقلاب العسكري المسلّح؟ وهل يمكن القول إن فخ الصدام الفلسطيني - الأردني (1970) غير قابل لأن يُستنسخ ولو بتدبير من طرف خارجي؟ ثم، هل كل اليمنيين استوعبوا دروس ما انتهى إليه يمنهم «السعيد» بتأثير انقلابات العسكر بعضهم على بعض؟ أسئلة قد تبدو قديمة جداً، لكنها لم تزل تتطلب إجابات.
GMT 02:30 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
السادة الرؤساء وسيدات الهامشGMT 02:28 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
«وثائق» عن بعض أمراء المؤمنين (10)GMT 02:27 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
من يفوز بالطالب: سوق العمل أم التخصص الأكاديمي؟GMT 02:26 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
روبرت مالي: التغريدة التي تقول كل شيءGMT 02:24 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
السعودية وفشل الضغوط الأميركيةصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©